إدموند أمران المالحي، الذي يُلقب بـ "جويس المغربي"، غادرنا منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا. سيمون بيتون، التي تعترف بجذريتها الأخلاقية والجمالية، في مواجهة الصهيونية ومن أجل فن رمزي، بلا تنازلات، تكرّس له فيلمًا وثائقيًا، بكل دقة وقوة تعبيرية، "ألف يوم ويوم من الحج إدموند". تصف فيه كاتبًا متعدد الأبعاد وإنسانًا فريدًا، لا يتزعزع ومضياف.
كصائغة للكلمات والصور، اختارت سيمون بيتون، في الفيلم الوثائقي الذي خصصته للكاتب إدموند أمران المالحي (1917-2010)، أن تتبنى نبرة رسائلية في المخاطبة الثانية تأخذ من السمة الثقافية التي منحها أصدقاؤه في الرباط، أصيلة، باريس، الصويرة أو بني ملال، لقب الحاج. هذا اللقب الممزوج، المنقول، حاج إدموند، الذي يحمل عنوان الفيلم، أزال عنه كل شبهة غربة بالنسبة لأمة متآلفة، مكونة من الإسلام واليهودية وأشكال أخرى من الروحانية الشعبية، وأبرزت شخصيته كرجل لطيف، محترم. في إحدى إعلانات إيمانه التي تم تسجيلها في مجلة "الأزمنة الحديثة"، قال إنه "مغربي يهودي" (غير يهودي مغربي)، مؤكدًا على أسبقية أرضه على طائفته. وهكذا، عرّف عن نفسه بخطوة جانبية هوياتية، وعلاقته الاندماجية مع مجتمعه، وفنه في نسج الخيوط المختلفة التي تربطه برفق إلى محليته، وبالتالي، رغبته في إنسانية غير مركزية.
مغربي يهودي
ألف يوم ويوم من الحج إدموند. تتلخص في بيان الفيلم، المأساة الأصلية للتهجير التي تم تنظيمها منذ منتصف الخمسينيات، بين عشية وضحاها من قبل الوكالة اليهودية بالتواطؤ مع السلطات المغربية، من السكان اليهود الأمازيغ، الذين استقروا منذ أكثر من ألفي عام، والتذكير الحزين، الرمزي، الذي يقدمه المؤلف في مسار ثابت (ماسبروا، 1980)، ثم ألف عام يوم (فكر بري، 1986). قبر ناحون، الذي يُعتبر آخر يهودي مدفون في أصيلة، يتناوله المؤلف، بينما ينشر روايته الأولى في سن الثالثة والستين، ليقول "الموت الرمزي لجماعة وجذورها في هذه الأرض". ليس فقط من أجل فلسطين المسلوبة، بل لأن هذا الكاتب، المعارض بشدة للسياسة الاستعمارية الإسرائيلية، يشعر بالاستياء من الصهيونية، ولكن بشكل أكثر جوهرية لأنه أفقَر، وأخلى بلده المغرب، كما فعلت دول عربية أخرى، من تعدديته الألفية.
عندما قابلت سيمون بيتون، وهي لا تزال شابة، متدربة في السينما، وقد هربت من إسرائيل في أواخر السبعينيات، في باريس، حيث نفي إدموند منذ عام 1965، كان يسألها طويلاً عن ظروف حياة السفارديم هناك. كان حلمها السري، المثالي، أن يشعروا هناك بالضيق ويقرروا العودة إلى وطنهم الحقيقي، المغرب. دون أن تدري، تحولت لاحقًا إلى شخصية محققة في نصوصه الأدبية. وقد ملأ رواياته، في عصارة جويسية، بأصداء، وروائح، وأصوات، وكلمات محلية، تعبر عن حزن الفقدان بقدر ما تعبر عن شعرية الارتباط.
حياة غنية
مثل مارسيل بروست، كان لفترة طويلة، شابًا في آسفي ثم في الدار البيضاء، خلال العشرينيات والثلاثينيات، يعاني من الربو بشكل مروع، ضعيفًا، محصورًا في المنزل العائلي. عندما يأخذ قلمه ليكتب عن ألمه الوجودي بعد عقود، يذكر "ميلاد شاب حكيم كان يحلم بأن يصبح مربيًا للكلمات".
جملته لا تسعى لتوثيق العالم، بل لإنشاء واحد، وعاءً لشرارات حياة لا يمكن اختزالها في سيرة ذاتية. حساسة لعالمه الغني، أضافت سيمون بيتون إلى فيلمها مشاهد طويلة تحكي عن جوانب من حياته ومشاهد ثابتة تدعو، كما في الجذور، إلى استكشاف الشرايين العديدة التي ترسمها كتاباته. ونظرًا لأن الإلحاح الذي كان يشعر به كان أخلاقيًا وجماليًا في آن واحد، فقد أعادت رسم مساره الفريد، من المقاومة والشيوعية، التي كانت مرهقة بسبب الستالينية، ولكنها لا يمكن تجاوزها لقيمه، إلى ورش الفنانين الرسامين غير القابلين للتصنيف (أحمد الشرقاوي، خليل غريب، حسن بورقية ...) الذين أحبهم لأنهم كانوا منتبهين إلى العابر وغير القابل للتجاوز.
على مدار الفيلم، تعيد بناء وفرة من الحب، أولاً لرفيقته، ماري سيسيل دوفور، التي تعرفت عليها في الدار البيضاء، حيث كانا يدرسان الفلسفة معًا، قبل النفي. لقد كانت لفترة طويلة بمثابة مقياس لحياته. متخصصة في والتر بنيامين، شبيهته، كانت تقول، تقريبًا على سبيل المزاح، إنهم كانوا يشكلون معًا مثلثًا. قليلة الكلام، كانت تراقب بعناية تامة تماسك عالمه، وقوة نصوصه وحقها في الغموض، وتأخذه معها إلى مطحنة والديها في بورغون، وتعود معه بالسيارة، بانتظام، بعد عشر سنوات من النفي، كل صيف، إلى مغربه المحبوب.
في شقتهم الصغيرة في 114 شارع مونبارناس في باريس، على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، كانت لديها مهنة النسج وكان لديه خزانة استخدمها كمطبخ لتحضير أطباقه المتبلة، وحولهم كان هناك باليه لا ينتهي من الأصدقاء، حيث تلاقت المغرب وفلسطين ولبنان والفلسفة والنقاشات السياسية والضحكات الصريحة وإحساس دائم بأنهم مرحب بهم من قبل زوجين محبين يتوقان إلى الأطفال. في منزلهم، كان يجتمع دون شكل أناس حساسون للاضطهادات والمآسي في العالم وغالبًا ما يناقشون ذلك بإنسانية راديكالية.
في الفيلم، يروي محمد توزي، دومينيك إدي، ليلى شاهيد، رضا بنجلون وعبد الرحيم يامو، بالتناوب، حلقات من هذه الحياة الجيدة، وتفاصيل وعي سياسي مضطرب، ولكن في نفس الوقت صدى لصوت أدبي بارز. لم يستسلم الحاج إدموند أبدًا لنداءات صالونات باريس ولا إلى ثريات فرنكوفونية مضللة. ارتباطه، بالإضافة إلى أرضه، هو بلغته الأم، وصرامة الأصوات التي تعبر النص المكتوب لتمنحه عصارة وكثافة ذاكرية. ومرة أخرى، بعد عودته إلى الوطن، بعد مغادرة ماري سيسيل، وبمساعدة صديقه الكاتب محمد برادة، سيكون هناك حلقة أخرى في مسكنه الجديد في أغدال، الرباط، بدءًا من عام 1999 حتى مغادرته.
شخصية الحاج إدموند
تأخذ تسمية الحاج إدموند كل معانيها، لأن هذا هو ما يناديه الناس العاديون في بلده. ولكن بالإضافة إلى فعل الاحترام، فإن ذلك يختتم قوة صداقة عميقة مع أشخاص من جميع الأطياف، الذين يتبنونها كواحد من بينهم. "الكبيرة"، المرأة التي كانت تعتني به والتي كان يمدح طعامها، تقول ذلك بشكل عفوي في الفيلم: "كان يهوديًا مسلمًا". في الضريح، الذي تم بناؤه رمزيًا على شرفه في مقام، يتم التعبير عن هذا التآلف، الذي يبرز ارتباطه بروحانية مختلطة، قديمة، مكانيًا. تمامًا كما أن دفنه، بعد وفاته في 15 نوفمبر 2010، في المقبرة اليهودية في الصويرة، التي أعيد فتحها لهذه المناسبة، يرمز إلى دفنه في أصيلة حيث وضع بشكل خيالي ناحون، آخر يهودي مدفون.
كان تصوير الفيلم الوثائقي قد اكتمل تقريبًا قبل 7 أكتوبر 2023، لكن مونتاجه تم طوال هذه الفترة المأساوية غير المحتملة. تقول سيمون بيتون إنها تمكنت من الصمود لأن، في مواجهة الكارثة، كان هذا دينًا. كان إدموند أمران المالحي من بين هؤلاء اليهود العرب القلائل، الذين لا يمكن تعزيتهم من الخطف السياسي الذي حدث في المغرب، كما في الجزائر، تونس أو العراق، على أنقاض النازية، كما أنه لم يكن متساهلاً بشأن حق الفلسطينيين في دولتهم والعودة الشرعية. لم يكن ذلك كناشط سياسي أو كمنتج لخطابات متوقعة، بل كنساج للقصص، ومثير للذكريات ومربي لا يشبع من الكلمات الصحيحة.
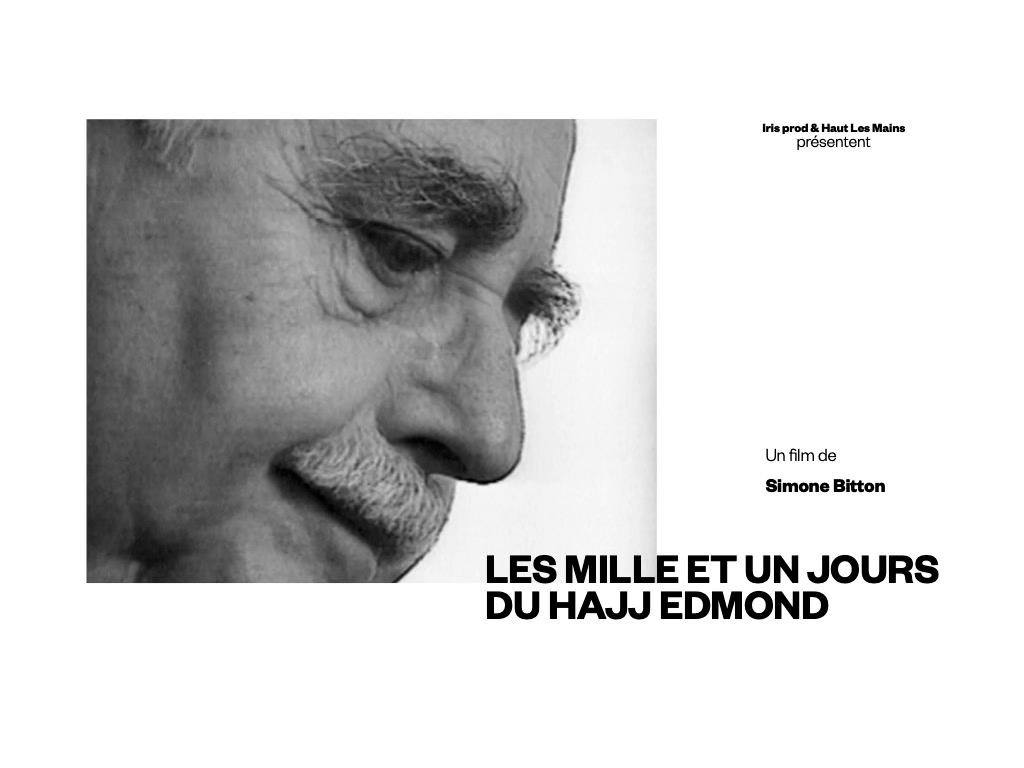
دريس كسيكس كاتب، مؤلف مسرحي، باحث في الإعلام والثقافة وعميد مشارك للبحث والابتكار الأكاديمي في HEM (جامعة خاصة في المغرب).
